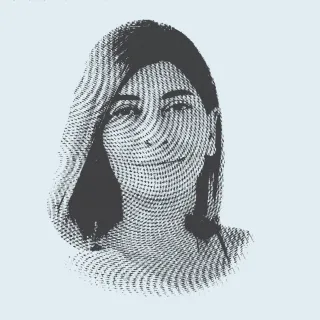ما تحت السطح في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يفسَّر بتوازن السلاح وحده، بل بتوازن السرديات. فإسرائيل، رغم تفوقها العسكري والتقني والتنظيمي، لا تكتفي بالقوة الصلبة، بل تستند إلى قوة ناعمة، تجعل أفعالها، مهما بلغت من قسوة، قابلةً للتبرير داخل المجتمعات الغربية. هنا تتولد الحيرة: كيف يمكن لمنظومة تدّعي الدفاع عن العقل والأخلاق وحقوق الإنسان أن تدعم دولةً ترتكب انتهاكات موثقة دون مساءلة؟
الجواب يبدأ من التاريخ، لا من السياسة. فإسرائيل لم تُبنَ في الوعي الغربي دولةً طبيعيةً، بل مشروع أخلاقي مرتبط بعقدة الذنب الأوروبية بعد المحرقة. هذا الإرث لم يُعالَج بوصفه مأساة إنسانية عامة، بل جرى تحويله إلى التزام دائم بحماية إسرائيل. وهكذا انتقل الشعور بالذنب من كونه درساً أخلاقياً إلى حصانة سياسية، جعلت إسرائيل فوق النقد، وفوق القانون. في هذا السياق، تشكلت سردية تعتبر أي مساءلة لإسرائيل تهديداً أخلاقياً. مصطلح «معاداة السامية» خرج من معناه التاريخي بوصفه توصيفاً للعنصرية، ليتحوَّل إلى أداة ردع فكرية. المفارقة أنَّ العرب هم ساميون أيضاً، لكن هذا الواقع يُستبعد من الخطاب. النتيجة أن الفلسطيني يُجرَّد من صفة الضحيَّة، بينما تُحتكر صفة الضحية لصالح طرف واحد، مهما امتلك من قوة.
الطبقة الثانية تحت السطح هي هيمنة الصورة. إسرائيل نجحت، عبر الإعلام والسينما والجامعات ومراكز الأبحاث، في ترسيخ صورة «الدولة المحاصرة» التي تدافع عن نفسها، بينما يُقدَّم الفلسطيني باعتباره تهديداً أمنياً. بهذه الطريقة تُمحى السياقات التاريخية للاحتلال والاستيطان،
تلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في تثبيت هذه المعادلة. إسرائيل ليست مجرد حليف، بل امتداد وظيفي في منطقة حساسة. الدفاع عنها يعني الدفاع عن النفوذ الأميركي نفسه. لذلك لا يُستغرب أن تُواجَه قرارات محكمة العدل الدولية، حين تدين أفعال إسرائيل، بردود فعل عقابية من واشنطن.
لكن السؤال الجوهري هو: هل هذه السردية ثابتة؟ الواقع يشير إلى أنها قوية، لكنها ليست أبدية. فالسرديات، مهما بدت محصنة، تتآكل حين يتراكم التناقض بين الرواية والواقع. ما نشهده اليوم هو بداية تصدع بطيء داخل المجتمعات الغربية، لا داخل الحكومات بالضرورة. الجامعات، وحركات الشباب، ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى أصوات يهودية ناقدة، بدأت تطرح أسئلة لم تكن مطروحة سابقاً.
تغيير السردية لا يتم بالصراخ، بل بأدوات دقيقة. أولى هذه الأدوات اللغة. الخطاب العربي غالباً يخاطب ذاته، لا الجمهور الغربي. المطلوب لغة القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والتاريخ المقارن؛ أي اللغة التي يحاكم بها الغرب نفسه. الأداة الثانية هي الاستثمار الطويل في المعرفة: مراكز بحث، وإعلام محترف، وسينما، وأدب، وصحافة استقصائية قادرة على منافسة الرواية السائدة.
الأداة الثالثة هي فصل اليهودية ديناً وثقافةً عن الصهيونية مشروعاً سياسياً. هذا الفصل يحرر النقاش من الابتزاز الأخلاقي، ويمنع احتكار الحديث باسم اليهود. وجود أعداد كبيرة من اليهود في مواقع التأثير لا يعني تجانس مواقفهم، بل إن كثيراً منهم باتوا في طليعة النقد الأخلاقي لإسرائيل.
أما الأداة الرابعة، فهي العمل داخل الغرب، لا ضده، ببناء تحالفات مع قوى مدنية وحقوقية، ومع إعلاميين وأكاديميين مستقلين، أكثر فاعلية من خطاب المواجهة الشاملة. فالسرديات لا تسقط بالخصومة، بل بالاختراق الهادئ والمراكمة.
ويظل البعد الديني عاملاً حاسماً في تثبيت هذا الدعم، خصوصاً داخل التيارات الإنجيلية في الولايات المتحدة، حيث تُقدَّم إسرائيل جزءاً من نبوءة لاهوتية، لا دولة تخضع للمساءلة. هذا التداخل بين الدين والسياسة يمنح السردية الإسرائيلية بعداً عاطفياً يصعب اختراقه، لأنه يحوّل الموقف السياسي إلى واجب إيماني. في مواجهة ذلك، لا يكفي النقد السياسي، بل يتطلب الأمر خطاباً معرفياً يوضح كيف جرى توظيف النصوص الدينية لخدمة مشروع قومي حديث، وكيف تم تديين السياسة لإسكات أي اعتراض عقلاني. إلى جانب ذلك، ينبغي الاعتراف بأن العالم العربي نفسه أسهم، أحياناً دون قصد، في إضعاف روايته، عبر غياب العمل المؤسسي طويل المدى، والاعتماد على ردود الفعل. فالسرديات لا تُدار بالأزمات، بل بالنَّفَس الطويل. إعادة التوازن تتطلب صبراً، واستثماراً في الإنسان، والتعليم، والقدرة على مخاطبة الآخر بلغته ومنطقه. بهذا المعنى، فإن تغيير السردية ليس معركةً عاجلةً تُحسم في موسم سياسي واحد، بل مسار تراكمي. قد لا تظهر نتائجه سريعاً، لكنه وحده القادر على تحويل التعاطف الأخلاقي إلى موقف سياسي مستدام.
ولهذا فإن جوهر المأزق لا يكمن في اختلال موازين القوة وحدها، بل في عجزنا عن تحويل الفهم إلى سياسة، والرؤية إلى فعل منظم، فالصراع، كما يُدار اليوم، يُختزل في ردود أفعال آنية، بينما تُترك معركة الرأي العام بلا إدارة حقيقية. إن إعادة بناء الفهم تقتضي الانتقال من الانفعال إلى التحليل، ومن الشكوى إلى إنتاج معرفة قابلة للتداول، ومن الخطاب المحلي إلى خطاب عالمي، وحين يصبح الفهم مشتركاً، تتغير اللغة، وتتراجع الأساطير، ويضيق هامش التبرير الأخلاقي للعنف. عندها فقط، يمكن للصراع أن يُرى على حقيقته، لا كما تريد له السرديات المهيمنة، بل كما هو: قضية شعب حُرم من حقه، ونظام دولي أخفق في حماية مبادئه، ولا تُمحى بتفوق القوة، ولا بتراكم الأعذار، ولا بصمت المتفرجين، ولا بتواطؤ المؤسسات، فالفهم الدقيق هو البداية الوحيدة الممكنة لأي مسار عقلاني مستقبلي جاد.
آخر الكلام: في عالم تحكمه السرديات، لا يهزم من يخطئ، بل من يعجز عن الشرح.
محمد الرميحي